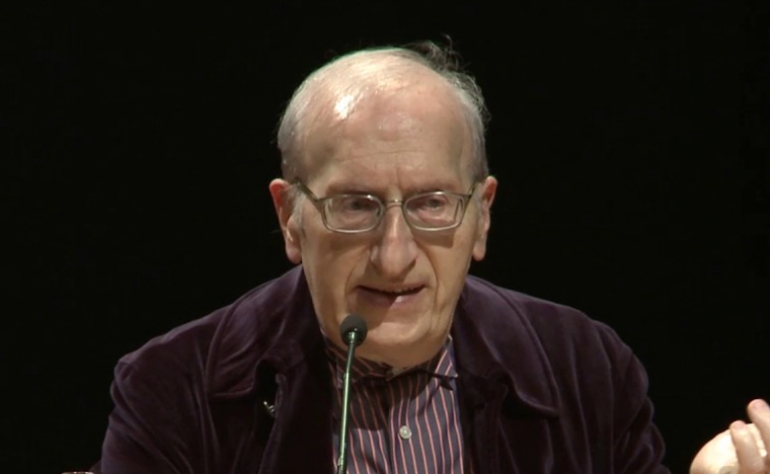مقتطع من مقال لـ: جون كلود ملنار، السلطات من نموذج إلى آخر، مجلة إليسيداسيون، مارس 2003
Jean–Claude Milner, «Les pouvoirs: d’un modèle à l’autre», Élucidation, mars 2003
ترجمة محمد عادل مطيمط
في هذا المقال، الذي قالت عنه الأستاذة الفرنسيّة كاترين كنسلار إنه يطرح أهمّ نظريّة سياسية معاصرة
« Laïcité et philosophie », Archives de philosophie du droit « La Laïcité », tome 48, Paris : Dalloz, 2005, p. 43-56)
يطرح «جون كلود ملنار» مسألة الانتقال مما يسميه «النموذج السياسي الكلاسيكي» (أو «النموذج السياسي للحدّ»
Modèle politique de la limite)،
إلى النموذج السياسي اللّا-كلاسيكي
Modèle politique non-classique
الذي يتميّز بانفتاح مجال انطباق السلطة وانهيار المراكز التقليدية للقرار وتحوّل الدولة إلى أقلية من بين أقليات لا حصر لها قادرة على ممارسة السلطة.
إذا كان النموذج الأول يرتبط بصورة الدولة الموروثة عن اتفاقية «وستفاليا» 1648 ، أي الدولة الوطنية المحدودة جغرافيا والمحدودة سياسيا أيضا نظرا لارتباط السلطة بمراكز محددة للقرار والتشريع وفقا لما تمليه نظرية السلطات الثلاث، فإن النموذج الثاني يرتبط بتلاشي الحدود الجغرافية الوطنية للسلطة (العولمة) من جهة، ومن جهة أخرى بانفصال سلطة سنّ القوانين عن السلطة التشريعية لكي تصبح قدرة تتمتع بها كل جماعة أو هيئة تكون قادرة على فرض قوانين جديدة أو تعطيل القوانين القائمة بما في ذلك السلطة القضائية أو أية أقلية اجتماعية أخرى. فهذا النموذج الثاني يفتكّ السلطة من المركز ويحيلها إلى ما يسميه الكاتب بالأقليات التي هي ليست أقليات اتنية أو عرقية فقط بل كل جماعة أو مؤسسة مستقلة وذات نفوذ منفصل عن نفوذ الدولة التقليدية، حيث تصبح الدولة نفسها في النهاية مجرّد أقلّية.
ولكن المفارقة في كل ذلك هي أن انفتاح السلطة في النموذج اللا-كلاسيكي قد أدّى إلى ضمور المراكز الوطنية التقليدية من جهة، ولكنه من جهة أخرى أدّى إلى توسّع نطاق سلطة مركزية لدولة وحيدة هي سلطة الولايات المتحدة الأمريكية التي استأثرت بكل المقوّمات التي تجعل مجال انطباق نفوذها لا-كلاسيكيا ولا-محدودا. قد يكون الواقع اليوم مختلفا نسبيا عمّا
كان عليه في الفترة التي كتب فيها «ج. ك. ملنار» هذا المقال (2003، أي الفترة التي قادت فيها الولايات المتحدة حربا عالمية على العراق وبلغ فيها نفوذها العالمي ذروته)، حيث يتعرّض النفوذ الأمريكي العالمي إلى مقاومة شديدة من قبل قوى عالمية أخرى صاعدة (الاتحاد الروسي والصين الشعبية خاصة)، إلا أنّ فكرة انهيار النموذج الكلاسيكي للسلطة، أي نهاية السلطة التي تحتكرها مؤسسات الدولة الوستفالية، تبقى ذات مصداقية كبيرة. ولا ندري اليوم ان كانت المعارضة الشديدة لسلطة دولة الولايات المتحدة من قبل مجتمع الأقليات العالمي (المجتمع الوحيد، أو المعولم) ستكون تأكيدا للنموذج اللّا-كلاسيكي للسلطة، أم تراجعا نحو صورة الدولة الوستفالية الممثلة لنموذج السلطة الكلاسيكية.
نقدّم هنا مقتطفا من هذا المقال الذي نشر في العدد 6/7 من مجلة إليسيداسيون الفرنسية ، مارس 2003، بهدف استيضاح هذا التصور لمصير السلطة السياسية في زمن العولمة:
– السلطةُ هي آليّةٌ معترفٌ بها اجتماعيا، وهي قادرة على سنّ قواعد. لا تهمّ الطريقة التي يتمّ بها ذلك، سواء كان بالإضافة أو بالإلغاء أو بتعديل القواعد الموجودة. (…)» و»يَعْرِفُ كل هواة المسلسلات الأمريكية أنه لا قيمة لاعترافاتٍ مُتّهمٍ مَا، ما لم يُذكِّره رجال الشرطة بحقوقه الدستورية قبل استنطاقه. ولكن هذه القاعدة ناتجةٌ حصرًا عن قرارات قضائية خاصة تمّت مراجعتها سنة 1966 من قبل المحكمة العليا ، حيث لم يتدخل المشرّع في ذلك أبدا. ومن الواضح هنا أن هذا يختلف عن المنهج الفرنسي [في سنّ القواعد] الذي يمرّ عبر البرلمان (انظر مثالا على ذلك قانون افتراض البراءة
La loi sur la présomption ). (…)
لا شيء واضح بذاته في النموذج الكلاسيكي. والولايات المتحدة الأمريكية، على ما هي عليه اليوم، تُمثّلُ الحُجّةً على غياب هذا الوضوح. صحيح أنّها قد اتخذت منذ زمن طويل من صورة الدولة الوستفالية نموذجا لها. وصحيح أننا نلاحظ أحيانا أنها تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة وستفالية متضخّمة ستتعرّض في أقصى تقدير إلى تلك التقلّبات الكلاسيكية المتمثلة في العظمة والانحطاط. غير أن الواقع الراهن مختلف تماما.
ففي هذه الدولة نقف على نسق يكون فيه عدد السلطات كبيرا. يستطيع القضاة في هذا النسق أن يبتكروا قواعد قانونية ( توجد إذن سلطة قضائية). ويستطيع الصحافيون أن يبتكروا قواعد «حسن سيرة» سوسيو-سياسية (توجد إذن سلطة رابعة). صحيح أن التنظيم الفيدرالي له تأثيره، غير أنه يتسنّى في الواقع لكل كيان يشمله المجتمع أن يبتكر قواعدَ سواء كان يريد فرضها على الجميع أم لا. ثمّ إنّ كل كيان لا يدعي لنفسه تمثيل المجتمع بأكمله يستحقّ منطقيا تسمية الأقلية
لا معنى لمبدأ عدم التناقض بين القواعد في مثل هذا النظام. فلا يوجد قانون واحد، بل عدة قوانين، لا بل ربّما عدد لامتناهٍ من القوانين. وبذلك فإن الصراع بين القواعد يصبح دائما وليس استثنائيا، حيث يتمّ الحسم فيه عبر المحاكم بموجب قانون القاعدة الأقوى
La loi de la règle la plus forte .
وقد يحدث أيضا أن يتمّ الحسم في هذا الصراع حسب قانون الأقوى
La loi de plus fort
بالمعنى الأكثر ابتذالا للعبارة، ويحدث ذلك في شكل حلبة صراعٍ بين أطراف لا حصر لها: الشارع، الصحف، الاعلام المرئي… الخ. وبذلك فإن السلطة القضائية والعنف في الفضاء العام يمثلان وجهين لنفس الظاهرة، ممّا يدلّ على أنّ دولة القانون منخرطة في حقيقة الأمر في نظام الحالة الطبيعة. (…).
لا يمثل التمييز بين القاعدة والقانون هنا أمرا جوهريا. فما يسميه الكلاسيكون استثناءً يمكن تماما أن يُفهمَ على أنّه قاعدة أخرى، متناقضة مع القاعدة موضوع النظر، أو قل ببساطة إنها مختلفة عنها. فكل سلطة تتمتع بالسيادة ولكن ما من سلطة تكون مطلقة. كل سلطة يمكنها أن تلتقي بسلطة أخرى وتتواجه معها، فيكون بإمكانها أن تنتصر عليها أو أن تنهزم. ولكنّ الانتصار لا يكون حاسما ضرورةً وهو لا يؤدي حتما إلى اندثار السلطة المنهزمة.
لا معنى هنا لطرح سؤال التعريف الجيّد للقاعدة، أو قل إن الأمر يتعلّق بالأحرى بسؤال مفتوح للنقاش دائما، أي للصراع. فمن المستحيل أن نحدد مسبقا ما الذي يمكنه أن يكون الأفضل. ونرى بصفة خاصة، أن تعريفات ما هو عمومي وما هو خصوصي تكون متنوعة جدّا. تشهد على ذلك قواعد (ما يُعْرَفُ ب) الخطاب السياسي النزيه
(Le politiquement correct)
التي هي في حدّ ذاتها متناقضة ولامتناهية في ما يتعلق بمجال اشتغالها.
تتغير هنا صيغ طرح سؤال الأغلبية والأقلية . فهذا السؤال كان يستمدّ دلالته في النموذج الكلاسيكي من علاقته بالاقتراع ، حتى أنه يتسنّى للأغلبية أن تُخضع الأقلية، وحتّى أنّ ما يراه الجزء[الأغلبيّة] يصدُقُ على الكلِّ[الأغلبية والأقلّية] (حيث يفرض القانون نفسه على الجميع بما في ذلك أولئك الذين لم يصوّتوا عليه). ويعني ذلك أنّ الأغلبية في سلطة ما، هي من يتمتع بالقدرة على التأثير. أمّا في النموذج الأمريكي (اللّا-كلاسيكي)، فيكون لكل أقليّة الحق في إخضاع الأغلبية، طالما أن هذه الأغلبية في نظرها هي في حدّ ذاتها خليط غامض من الأقليات. يبقى هنا أن أقلّية ما، نكرة، لا تتحدد في العلاقة بالاقتراع بل بالمجتمع. إنّها لا تتحدّد سلبيا في تعارضها مع الأغلبية، ولكنها تتحدد ايجابيا من جهة كونها تعبّر عن نفسها كي تبتكر القاعدة. وبذلك فإنّ الأقليات تُشكّلُ الطرف الفاعل الحقيقي في السلطة. أي أن ماهيتها لا تكمن في العدد بقدر ما هي تكمن في إرادة ابتكار القاعدة. إن الأقليات لا توجد إلا من خلال تميّزها. فالسمة المُحدّدة هنا ليست هي الكتلة الجماهيرية ولا الأغلبية ولا كذلك الغموض ، بل هي وضوح القواعد والسُّلَطات.ِ ثمّ إنّ المساواة ليست على هذا النحو سوى الحدّ الأقصى للمجموع اللاّمتناهي لوضعيات اللاّمساواة القائمة [بين الأقليات] في سياق المواجهة.
ليس للعدد أهميّةً تُذكًرُ. فقد تكون أقليةٌ ما أكثر عددا من أولئك الذين لا ينتمون إليها. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، سيصبح ذوو الأصول الاسبانية، أو ربّما قد أصبحوا، أكثر عددا من غيرهم. غير أنهم لا يزالون مع ذلك يشكلون أقلّية، على الأقل بقدر ما هم قادرون دائما على أن يبتكروا قواعدهم. وبالمثل فإن السؤال حول ما إذا كان لمن هم أقلُّ عددًا – مثل المسيحيين الأصوليين – الحق في أن يفرضوا على من هم أكثر عددا منهم قواعدَ قاهرةً، هو سؤال لا معنى له إلا في إطار المذهب الكلاسيكي للاقتراع. فلا معنى لهذا السؤال في المذهب اللّا-كلاسيكي للسّلط. ما هو محلّ نظر هنا ليس حقّهم بل قوّتهم . والمداولة التي توصف بأنها ديمقراطية يمكنها أن تحصل داخل الأقليات، ولكنها لا تحصل فيما بينها. إنها تحصل في كل مكان ولكنها تتلاشى كالبخار بمجرد قيام الحاجة لقاعدة ما. لا قيمة للمداولة الديمقراطية إلا بما هي تمهيد لهذه الحركة المؤسسة لحياة المجتمع، ليس أكثر من ذلك.
يمارس الاقتراع هو الآخر في كل مكان ولكنه ليس سوى سلطة من بين السلطات. وقد يحصل أن يمتنع المرء عن التصويت دون الشعور بأية خسارة. بل إنّ الاقتراع لا يُفْرِزُ غالب الأحيان أغلبيةً واضحةً، حتّى أنه قد يتمّ اللجوء إلى سلطة غير منتخبة لتوضيحه. وليست مغامرة جورج بوش [ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2000] سوى مثال من بين عدد كبير من الأمثلة على ذلك. وقد أصابت تلك المغامرة أتباع التصوّر الكلاسيكي – عن دراية منهم أو من عدمها – بالصدمة، أي أنها أصابت تقريبا كل الناس في فرنسا. فقد بيّنت إلى أي حدّ ابتعدت الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا النموذج [الكلاسيكي].
ولا حاجة من جهة أخرى للبرهنة على أن اللوازم المادية للنموذج الكلاسيكي قد اندثرت. فالتنظيم الهرمي للمقاطعات يتعرّض باستمرار إلى التقويض بفعل تلك السلطات المتقاطعة. صحيح أنه توجد تفرّعات للقواعد، ولكنها تفرّعات كثيرة وتكون في غالب الأحيان مفكّكة. ثمّ إنه توجد قواعد غير متفرّعة (قواعد الخطاب السياسي النزيه ، و»التمييز الايجابي» الخ) (…).
غير أن ذلك لا يعني البتة عدم وجود دولة بين تلك السلطات المتعددة. يمكننا أن نلاحظ أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة قادرة على التدخل في كل مكان من المجتمع ودون حدود، وإلاّ فإنه سيسود قانون الأقوى الذي لن يكون في صالحها بصفة ضرورية ودائمة. ما يفسر ذلك على وجه الدقة هو أن الدولة لا تعلو فوق السلطات، بل تختلط معها باستمرار، دون أن تفرّط في ما تتميّز به من هيبة. وبتدقيق الملاحظة، سننتبه إلى ذلك الاستدعاء الدائم، عن وعي أو دون وعي، لقيم الجمهورية الرومانية: كتعظيم الشخصيات المرموقة، أو مدح البطولة و تعظيم القادة.
وبما أن الدولة تُعرّف باعتبارها إحدى السلطات القائمة فعليّا، فلا بدّ من وصفها بخاصيات تجريبية وليس أكسيوماتيكية. ولنفترض هنا أن سلطة الدولة تتميز بقدرتها على ابتكار القواعد في أربعة مجالات على الأقل: الجيش والعملة ، والأمن والضرائب، أعني ذلك التعريف الكلاسيكي لسلطة الدولة وللحدّ الأدنى من المواصفات الذي يجب أن يتوفر فيها. ستكون نتيجة ذلك هي أن غياب احد هذه المجالات سيؤدي إلى زوال سلطة الدولة. والمحصّلة هي: توجد سلطة دولة في الولايات المتحدة.
ولكن هذا التحديد الذي هو في حد ذاته تحديد كلاسيكي يتلاشى في غمرة العالم اللّا-كلاسيكي للمجتمع الحديث، حيث تنزع القواعد إلى الامتداد دون حدود، وحيث تتميز قواعد سلطة الدولة بصفة خاصة بالنزوع إلى عدم الاكتراث بالحدود.
فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك جيشا وعملة وشرطة ونظاما ضريبيا: والفضاء الذي يشتغل فيه العنصران الأولان هو العالم، وسيصل العنصر الثالث يوما ما إلى المستوى نفسه من الانتشار. أمّا في ما يتعلق بالعنصر الرابع فمن المعروف كيف أن سلطة الدولة (في الولايات المتحدة) تُتقن المزج بين القواعد الوطنية والجنّات الضريبية الخارجية التي تحوّلت بذلك
إلى مكونات للّعبة الداخليّة. إن بلدانا مثل الهند أو الصين لا تملك عملةً تشتغل خارج حدودها وخارج مجال سيطرة جيوشها، وهي لا تهتم حاليا إلا بجوارها المباشر. ثمّ إنه من المؤكد أن روسيا لديها جيش، ولكن ليس لها عملةً ولا نظام ضريبي ولا كذلك جهاز شرطة ناجع. أما أوروبا، فإن لها عملة دون شك، ولكنها على صعيد الجيش، لا تمتلك سوى فرق عسكرية من الاحتياطيين. من المؤكد أنها تمتلك أجهزة شرطة وضرائب، ولكنها ضعيفة ومحلية، في حين أن اليابان، ولمدة لا يستطيع احد أن يُقدّرَ متى تنتهي، فإنها لا تملك جيشا. والنتيجة هي أنه ليس هناك في العالم الراهن، أي في فضاء المجتمع الحديث، إلاّ سلطة دولة واحدة هي سلطة دولة الولايات المتحدة الأمريكية.
إن سلطة دولة الولايات المتحدة سلطة لا-كلاسيكية، أي انه ليس لها حدود ولا رقعة جغرافية محددة وينزع المجتمع الذي تتنزل فيه هذه السلطة إلى أن يكون هو الآخر وحيدا وعالميا. وبالتناسب مع ذلك فإنّ العالم بصدد التشكّل في صورة مجتمع واحد تخترقه أقليات وسلطات متنوعة توجد ضمنها سلطة دولة وحيدة. صحيح أن هناك بعض الأقليات تنظر إلى نفسها على أنها دول أو حتى على أنها أمم. هي حرّة في ما تراه. ولكن إذا قلنا إن لها سلطة، فتلك هي سلطة الأقليات: سلطة الاحتجاج في الحد الأدنى وسلطة إرادة ابتكار القواعد الجديدة في الحد الأقصى. ثمّ إنّ سلطة الدولة الوحيدة، مثلها كمثل أية سلطة، تجد في مواجهتها خليطا غامضا من الأقليات، بعضها يحمل أسماء تاريخية وحكومية (فرنسا، ألمانيا…الخ)، والبعض الآخر يتجلى في صورة منظّمات جديدة ومدنية ( مثل «السلام الأخضر و»أتّاك», …الخ ). وهناك أقليات أخرى تتخذ أسماء دينية («إسلام»، «مورمان» ..الخ). ثم إن بعض هذه الأقليات يوجد خارج حدود الولايات المتحدة والبعض الآخر داخلها. ولكن من زاوية نظر سلطة الدولة، لا توجد بينها فوارق البتة إلا تلك التي تسببها الظروف الطارئة.
إن سلطة الدولة نفسها، باعتبارها سلطة من بين سلط أخرى، تمثل بدورها أقلية ضمن أقليات أخرى. فهي تعتبر أن القواعد التي تبتكرها يمكنها أن تنطبق على عدد لامحدد من الأفراد. وذلك بالطريقة نفسها التي يعتبر وفقها أصحاب الخطاب السياسي النزيه أن قواعدهم صالحة في كل مكان لا تعوقهم فيه قاعدة أخرى تكون أقوى من قواعدهم. وبما أن ذلك يتعلق بأقليات على وجه الدقة، فان سلطة هؤلاء أو غيرهم هي سلطة عالمية بالقوة، بحسب منطق قانون الأقوى. يتمثل الاختلاف الوحيد في تعريف القوّة العسكرية والاقتصادية وقوة التخيّل …الخ.
بقي فقط أن ننتبه إلى أن سلطة الدولة تتمتع ببعض الامتيازات باعتبارها تنظم الجيش والعملة والشرطة والضرائب. إنها على وجه الخصوص، تمتلك مفاتيح الحرب والسلم. ولكن ذلك يتم بواسطة الاتفاقيات الممكنة التي تستدعيها طلبات الأقليات الأخرى مهما كانت. لا شيء أكثر من ذلك انسجاما مع النموذج اللا-كلاسيكي.
سواء كانت الأقليات حكومية أو غير حكومية، فإنها بمجرّد أن تُسمع صوتها تكون قد أثبتت هذا النموذج. يتم ذلك خاصة من أجل معارضة الأقلية التي تمثلها سلطة دولة الولايات المتحدة، فأقلية تعني هنا سلطة. لا بل إن احتجاجها نفسه يساهم في تركيز ذلك المجتمع الوحيد الذي ليست له سوى سلطة دولة وحيدة. وبهذا المعنى، فإنه ما من شريك أكثر خدمة لسلطة «بوش» من منظمة «أتّاك» أو من «يوشكا فيشر».